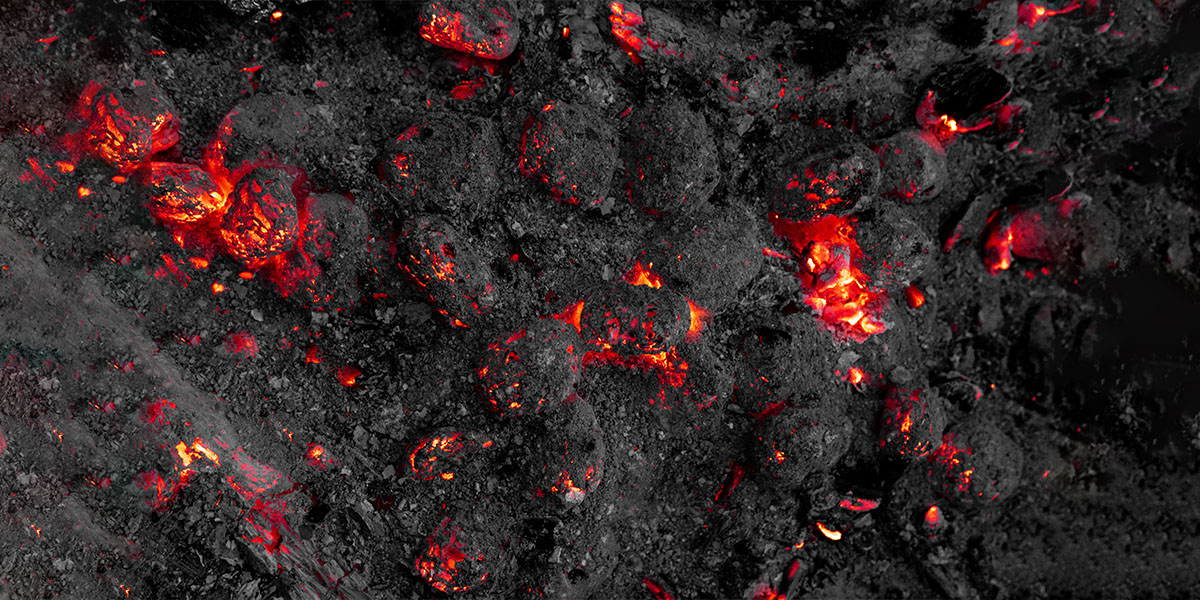
- أية ضرورة توجد للفتنة الكبرى التي طحنت رحاها فرقاء الأمة منذ قرون؟
- وماذا يميز المصلح الموعود في تناوله لموضوع الفتنة الكبرى في التاريخ الإسلامي عن سواه؟
__
التاريخ العلمي التاريخي للمصلح الموعود
في الأسباب والنتائج والملابسات
لا يكاد موضوع الفتنة الكبرى في التاريخ الإسلامي يُطرح، إلا وكان مورد اللعن من قِبل أغلب المسلمين، وهم محقون ولا شك، فحتى وإن تعددت الخلافات المذهبية بين المسلمين، فإنهم يتفقون على حقيقة أن وقائع تلك الفتنة الكبرى كانت مصيبة حاقت بالمسلمين منذ قرون خلت، وكان مُؤداها اشتعالاً متسلسلاً لفتن مستمرة بينهم إلى هذا الحين، حتى لقد باتت هذه الفتن المعاصرة أبرز أسبابٍ لِتعذر رأب الصدع، إذ يُخرج بعض المسلمين البعض الآخر من الملة، فأي وحدة تُرتجى بعد هذا؟! فكل محاولة لِلَمِّ الشمل والتقريب بين الفرق المتورطة في تلك الفتنة لا تبوء إلا بفشل ذريع، بل لا يزداد طين الخصومة بعدها إلا بلة. ولكن كما هي سنة الخلاق العليم، أن الليل كلما اشتد سواده، كان إيذانا باقتراب الفجر، وقد آن أن يطلع فجر الحقيقة على البائتين.
مشكلة قراءة الفتنة الكبرى والكتابة عنها
ثمة وضع غريب للغاية، طالما يتكرر كل مرة حين يضطر أحد الكتاب أو المؤرخين إلى استحضار مشهد الفتنة الكبرى لأجل إعادة كتابته أو الكتابة عنه، ذلك لأن الشخص العادي، مهما بلغت درجة موضوعيته وحياده، لا يلبث أن يفرِّط في تلك الموضوعية والحياد بين الفينة والأخرى، وهذا التفريط شيء عارض يحدث دونما قصد حقًّا، لا سيما إذا كان المرء بإزاء قضية ضاربة في القدم، ولم يعد ثمة شهود طبيعيين عليها، وعلاوة على ذلك يكون طرفا الخصومة فيها على درجات متقاربة، أحيانًا، من الخيرية والصلاح، ويصل الأمر لدى البعض إلى افتراض وجود خصومة بين طرفين متحابين، لمجرد سوء قراءة لبعض الروايات التاريخية، فمن الأخطاء الفادحة التي طالما يقع فيها العديد من مناقشي قضية الفتنة الكبرى أنهم يفرقون بين الخلفاء، فيفترضون، دون داع، وجود خصومة بين شخصين جليلين، تبوأ كلاهما المقام الرفيع، إنهما حضرة عثمان وحضرة علي (رضي الله عنهما وأرضاهما).. العجيب في أمر هؤلاء الكتاب أنهم لم يكتفوا بوضع كلا الخليفتين الراشدين كل منهما من أخيه موضع الخصومة، بل والمظلومية، بحيث جعلوا من أحدهما ظالما ومتجاوزا في حكمه، والآخر مظلومًا مغلوبًا على أمره حتى واتته الفرصة. وهذا قول واه لا أساس له سوى روايات لا تعدو أن تكون مجرد تلفيقات إذا ما قيست بتحقيقات هذا العصر.
وإنَّ ما كُتِبَ عن الفتنة الكبرى وظهور الفرق الإسلامية بلغ من كثرته حدًّا بحيث لم يعد هناك أي جديد ليقال بعد ما قيل، اللهم إلا بمدد وتأييد ممن عنده العلم الكامل سبحانه وتعالى.
فكل محاولة لِلَمِّ الشمل والتقريب بين الفرق المتورطة في تلك الفتنة لا تبوء إلا بفشل ذريع، بل لا يزداد طين الخصومة بعدها إلا بلة. ولكن كما هي سنة الخلاق العليم، أن الليل كلما اشتد سواده، كان إيذانا باقتراب الفجر، وقد آن أن يطلع فجر الحقيقة على البائتين.
الفتنة ليست شرًّا كلها!
ضرورتان كونيتان اقتضتا وقوع الفتنة الكبرى! فالضرورة الأولى تمثلت في التدليل على صدق نبوءة ماضية، تمثلت في حديث سيدنا خاتم النبيين الذي أنبأنا فيه بعمر الخلافة الراشدة بعده فقال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة…» (1). وقد كان، إذ لما استشهد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب بقتل أحد الخوارج له وهو عبد الرحمن بن عمرو المرادي في شهر رمضان لسبع عشرة ليلة خلت منه سنة أربعين هـ، بُويع بالخلافة بعده ابنه الحسن واستمر خليفة على الحجاز واليمن والعراق وخراسان وغير ذلك نحو سبعة أشهر تقريبًا، وكانت خلافته هذه المدة خلافة راشدة حقه لأن تلك المدة كانت مكملة لمدة الخلافة الراشدة التي أخبر النبي أن مدتها ثلاثون سنة ثم تصير ملكًا. وقال شارح الطحاوية: «وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهر، وخلافة عمر عشر سنين ونصفاً، وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة وخلافة علي أربع سنين وتسعة أشهر، وخلافة الحسن ستة أشهر» (2)، فتم بذلك الثلاثون سنة التي أنبأ عنها النبي الخاتم . فلولا وقوع الفتنة وما ترتب على تلك المصيبة من انقضاء أجل الخلافة الراشدة الأولى على منهاج النبوة، وبدء حقبة المُلك، وفق نبوءة النبي الصادق المصدوق ، لكان في عدم وقوع تلك الفتنة مصيبة أشد، حتى وإن عاشت الأمة في ازدهار ظاهري، إذ ما جدوى ذلك الازدهار وقيمته في ظل عدم تحقق صدق نبوءة قطعية واضحة ذكرها سيدنا خاتم النبيين وعلمها لصحابته أجمعين؟!
فالحاصل في هذا المقام أن وقوع الفتنة كان مصيبة ولا شك، ولكن عدم وقوعها كان سيشكل مصيبة أدهى وأمر!
والضرورة الكونية الثانية التي استدعت وقوع الفتنة تمثلت في الاستعداد المستقبلي لتحقيق نجاحات كبرى، لا سيما بعد الإصابة بجرثومة الفتنة الأولى بما أحدث أثرًا روحيًّا يشبه بدرجة كبيرة الأثر الطبي للأجسام المضادة، والذي يُحدثه إصابة الجسد بجرثومة مادية. فالفتن على اختلاف أشكالها هي تمارين واقعية لبلوغ الترقيات المتنوعة، وحتى إيمان المرء لا يترسخ لولا الابتلاء بالفتن، يقول تعالى:
فالفتنة إذن أمر حيوي من أجل صحة المجتمعات والأمم، واجتيازها معناه بلوغ تلك الأمم درجات رقي أعلى. ويبقى أمر ضرورة الفتنة ضمن حدود قوله تعالى:
فحتى الشيطان له دور يؤديه في هذه الدنيا، دور جعله الله تعالى له حصرًا، وهذا الدور يصب في مصلحة المؤمنين في المحصلة، أفرادا كانوا أو جماعة.
علم تشريح التاريخ
بمبضع طبيب جراح حاذق يشرِّح المصلح الموعود سيدنا بشير الدين محمود أحمد، الخليفة الورم السرطاني الكامن في نسيج أعضاء جسد الأمة منذ أربعة عشر قرنًا، ممثلًا في الفتنة الأولى، ويجري تشريحه بين يدي نخبة من الأكاديميين الأوروبيين في جلسة جمعية مارتن للتاريخ بالكلية الإسلامية بلاهور في السادس والعشرين من فبراير عام 1919، وكان البحث الذي ألقاه حضرته على الحضور هو ما نعرفه الآن بكتاب «بداية الخلافات في الإسلام»، والذي لم ينتهج المؤلف فيه منهجًا وصفيًا في كتابة التاريخ كسابقيه، وإنما انتهج منهجا تحليليًّا وتقصَّى الحقائق بأسلوب منقطع النظير استعصى حتى على أولئك المعاصرين للحدث. فقد توجه حضرته إلى أصل الداء مباشرة، فشخصه أوضح تشخيص، وأزال التراب المتراكم حول جذر شجرة الفتنة الخبيثة، تمهيدًا لإجاحتها من أصلها بكل اقتدار، إذ أماط حضرته اللثام عن أسباب الفتنة وملابساتها، وكيفية تطور أحداثها. ولم ينس حضرته على مدى صفحات الكتاب أن يبرئ ساحة الصحابة الكرام جميعهم مما نسب إليهم من تهم ألصقت بهم بسوء النية أو عن غير عمد، الأمر الذي تعذر على مَن سواه مِن المؤرخين والمفكرين إلى عصرنا هذا نظرًا إلى ميلهم المسبق إلى أحد المعسكرين وافتقادهم الموضوعية. ولا نبالغ لو قلنا أن هذا الكتاب يعد بكل صدق فرصة ثانية للأمة لتتشبث من جديد بأهداب الخلافة الراشدة بعد أن أفلتتها من يدها منذ أربعة عشر قرنًا.
والمؤلف بعمله هذا وغيره يستحق عن جدارة لقب المصلح الموعود، فهذا الكتاب أحد آثار إصلاحاته للفساد المستشري في جسد الأمة منذ قرون على الصعيد الفكري والعقائدي.
والقارئ للكتاب سيلحظ الموضوعية التامة للمؤلف، ووقوفه على المسافة نفسها من كلا المعسكرين، الأمر الذي لا يتأتى إلا لحكمٍ عدل. فهذا الكتاب على صغر حجمه إلا أنه عظيم المحتوى بالغ الأثر في شفاء الجرح القديم. وكيف لا؟! وهل يرد المال المسلوب إلا أهله؟!
هذا الكتاب نهديه إلى …
نظرا إلى القيمة العلمية التي يتضمنها كتاب «بداية الخلافات في الإسلام»، فإن شعورًا ما ينتاب كل قارئ له منتفع بما فيه، ذلك الشعور يتمثل في رغبة عارمة في عرض هذا الكتاب القيم على تلك النخبة من المفكرين المسلمين المحسوبين على تيار المتنورين، والذين نجدهم، إمعانًا منهم في محاولة إثبات تنورهم، يكيلون التهم والانتقاصات لمقام صحابة النبي الخاتم بدعوى أنهم ليسوا سوى بشر كسائر البشر، بل ربما هم أقل من حيث مستوى الإنسانية، وحاشاهم بالطبع. فنقول لهؤلاء المتنورين أن الصحابة بالفعل كانوا بشرًا كسائر البشر، وهذا لا ينتقص من درجاتهم الروحانية شيئًا، وأن من هؤلاء الصحابة من ثبت خطؤه في أحداث الفتنة مدفوعًا بحسن النية في كل الأحوال، وهكذا خلقنا الله تعالى خطائين، وإلا لما كان ثمة أي معنى للتوبة والإنابة. ولكن علينا قبل الانسياق وراء هذه المقولة أن نستثني منها مقامي النبوة والخلافة، إذ هما مقامان روحانيان يصــــــطفي الله تعـــالى لهما من يشـــــاء من عبــــاده الأطهــــــار، والله أعلــم حيــــــث يجعل رســـــــالــته!
الهوامش:
- رواه أبو داود، والحاكم، والطبراني بلفظ: “خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء”.
- ورواه الترمذي، وأحمد، والنسائي في “السنن الكبرى”. بلفظ: “الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك”. ((شرح الطحاوية)) (ص: 545).
- (العنْكبوت: 3-4)
- (القمر: 50)