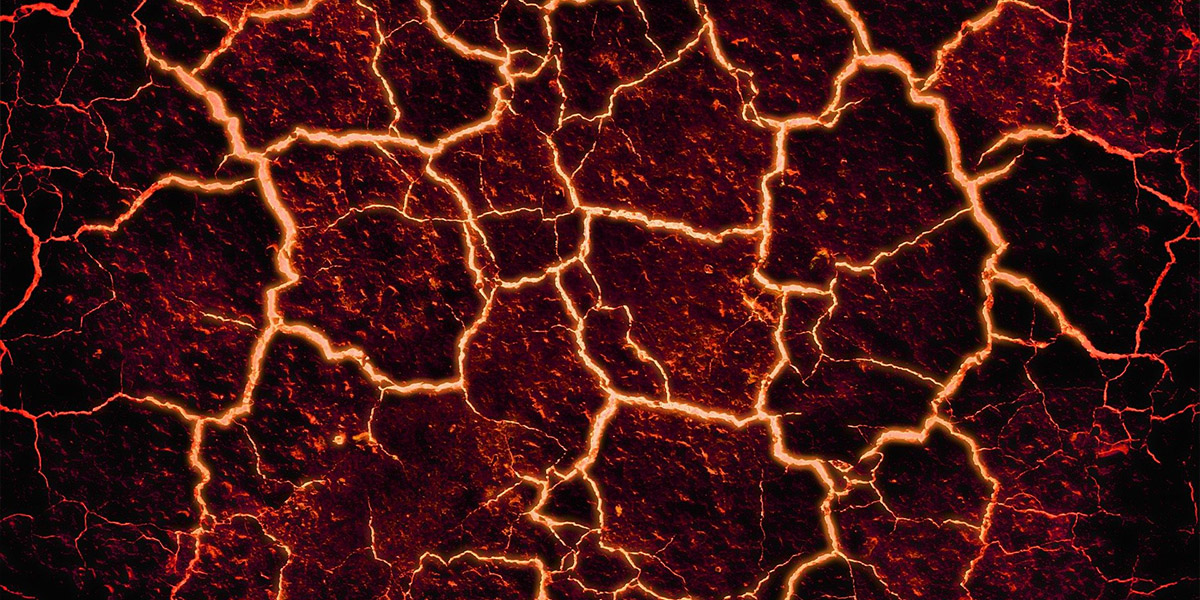
شرح الكلمات:
قلوبهم: راجع شرح كلمات قول الله تعالى (ختم الله على قلوبهم…).
المرض: كل ما خرج بالإنسان عن حد الصحة من علة ونفاق وشك وظلمة ونقصان وتقصير في أمر (الأقرب).
والمرضُ الخروجُ عن الاعتدال الخاص بالإنسان، وذلك ضربان: الأول مرض جسمي وهو المذكور في قوله: ولا على المريض حرجٌ ، والثاني عبارة عن الرذائل كالجهل والجبن والبخل والنفاق وغيرها من الرذائل الخلقية… ويُشبَّه النفاقُ والكفر وغيرها من الرذائل بالمرض، إما لكونها مانعةً عن إدراك الفضائل كالمرض المانع للبدن عن التصرف الكامل، وإما لكونها مانعة عن تحصيل الحياة الأخروية… وإما لميل النفس بها إلى الاعتقادات الرديئة ميلَ البدن المريض إلى الأشياء المضرّة. ولكون هذه الأشياء متصوَّرةً بصورة المرض قيل: دَوِيَ صدرُ فلان ونَغِلَ قلبُه (المفردات).
عذاب: راجع شرح كلمات قول الله تعالى (ولهم عذاب عظيم).
أليم: موجع (الأقرب).
عذاب أليم: أي مؤلم (المفردات).
يكذبون: كذَبَ: أي أخبرَ عن الشيء بخلاف ما هو مع العلم به؛ ضدُّ صدَقَ، وسواءٌ فيه العمد والخطأ (الأقرب).
التفسير:
لقد بين الله في هذه الآية أن عدم عَملهم وفق الفطرة السليمة دليل على أن قلوبهم مريضة، وإلا لأحسّوا على الأقل بما تُمليه عليهم الفطرة السليمة. وكما أن زيادة مادة الصفراء تُفسد طعم اللسان حتى إنه يجد الحلو مُرًّا، كذلك فمن كان في قلبه مرض لا يستطيع سماع صوت فطرته السليمة على ما يُرام.
ويراد بالمرض في هذه الآية النفاق. لقد ذكَرت هذه السورة في الركوع الأول أصحّاء الروح وهم المتقون، ثم ذكَرت المصابين بمرض الكفر، أما الآن فتحدثت هنا عن مرض النفاق.
ولقد ذكر النبي علاماتٍ لمرض النفاق فقال إن المنافق: إذا حدَّث كَذَبَ، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهَدَ غَدَرَ، وإذا خاصَمَ فَجَرَ. (البخاري، كتاب المظالم وكتاب الشهادات).
هذه العلامات من لوازم النفاق، لأن المنافق يريد أن يخفي نفاقه، وليس سبيل ذلك عنده إلا أن يلجأ إلى الكذب والشجار والسباب إذا اتهمه أحد وكشف عيبه، لكي يشغل الناس عنه. ثم إنه لا بد للمنافق من إخلاف الوعد والغدر، لأن المنافق هو من يكون مع القوم في الظاهر ويخالفهم في الواقع. ثم من لوازم المنافق أن يخون الأمانة، إذ من المحال أن يحظى بالقبول عند الأغيار ما لم يُفشِ لهم أسرار قومه.
وفي قوله تعالى: فزادهم اللهُ مرضًا… قد نُسِبَت زيادة المرض إلى الله تعالى، وذلك لأنها نتيجة لمخالفة أحكام الله وقوانينه، وأيضا لأن الله تعالى هو الذي يأتي بنتائج أعمال الناس، حسنةً كانت أو سيئة. والحق أن الله تعالى لم ينزل القرآن الكريم ليزيد الناس مرضًا، بل أنزله شفاء لهم من الأمراض حيث يقول تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ (يونس: 58).
والمرض المذكور في الآية قيد التفسير هو فقدانُ قوة الحسم، والجبنُ والنفاقُ، كما قال الله تعالى في آية أخرى: فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ (التوبة: 77).
أما زيادة مرض المنافقين فكان بطريقتين: أولا: كلما زاد الله تعالى المسلمين تقدمًا وقوة، اضطر المنافقون إلى زيادة النفاق -خلافًا لعقيدتهم الحقيقية- لكي يرضوا المسلمين، مع تضايقهم الشديد برؤية ازدهار الإسلام وشوكته. وقد عبّر القرآن الكريم عن هذا المعنى بقوله: إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ (آل عمران: 121).
وثانيا: لقد نزلت شريعة الإسلام تدريجيًا، فكلما ازدادت الأحكام والمسائل ازداد المنافقون نفاقًا وقلقًا وجبنًا، كما قال الله تعالى: فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ (محمد: 21).
لقد قال الله تعالى في الآية السابقة عن الكفار: ولهم عذاب عظيم ، بينما قال هنا عن المنافقين: ولهم عذابٌ أليم ، والسبب الفارق بين العذابين أن الكفار مهما تعرضوا للعذاب إلا أنهم يناوئون الإسلام ويحاولون بذل جهدهم للقضاء عليه، وهكذا يشفون غليلهم بصب جام غضبهم وبالانتقام. أما المنافقون فإنهم يخفون ما في قلوبهم وهكذا يموتون كمدًا، ولذلك وصف الله تعالى عذابهم بأنه عذاب أليم، أي أنهم إلى جانب الآلام يتجرعون الغصص أيضًا.
شرح الكلمات:
لا تُفسدوا: الفساد خروجُ الشيء عن الاعتدال، قليلا كان الخروج منه أو كثيرًا، ويضادُّه الصلاحُ (المفردات).
الأرض: النَّفْضَة والرِّعْدَةُ (التاج).
الأرض: الكرةُ الأرضية؛ وكلُّ ما سَفُلَ فهو أرض (الأقرب).
مصلحون: أصلح بين القوم: وفَّق، وأصلحه: أقامه بعد فساده (الأقرب).
التفسير:
الأرض في اللغة العربية تعني الكرة الأرضية كلها، وجزء الأرض الذي يكون تحت شيءٍ أيضًا يُسمى أرضًا. وأَرْضُ النَّعْل ما أَصاب الأَرض منها، وكل شيء هو في الأسفل أو متواضع ومقهور يُسمى أرضًا. يُقال فلانٌ إنْ ضُرب فأرضٌ، أي لا يُبالي بالضرب. والأرضُ الـمُلكُ والقُطرُ، يُقال: أرضُ الشام وأرض مصر. (اللسان وتاج العروس)
والأرض في هذه الآية تعني الـمُلك والقُطر، لأن المنافقين المذكورين لم تكن أعمالهم ذات صلة بالعالم كله، وإنما كانت تخص بلاد العرب أو حدودها.
كان فساد المنافقين يظهر في تصرفاتهم المختلفة التالية:
1- إثارة الشقاق بين المهاجرين والأنصار، متخذين الحمية القومية ذريعة لتحقيق أغراضهم الهدامة. في غزوة بني المصطلق حصل خلاف بسيط بين المهاجرين والأنصار، وكان عبد الله بن أُبيّ بن سلول في تلك الغزوة، فاستغل اختلافهم وأثار ضجة وقال للأنصار إن هؤلاء المهاجرين قد جاؤوا من الخارج ويريدون أن يحكموا علينا، وأنتم الذين أعطيتموهم هذه الفرصة، فلو لم تساعدوهم لتشتتوا وتشردوا تلقائيًا (سيرة بن هشام). وقد ذكر الله تعالى قولهم هذا في القرآن الكريم فقال: هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا (المنافقون: 8)، أي أن المنافقين هم الذين يقولون لا تنفقوا أموالكم على الذين اجتمعوا حول محمد رسول الله لكي يتشتتوا بأنفسهم. وعندما رأى عبد الله بن سلول أن الأنصار قد استشاطوا غضبًا أراد أن يقضي على الأساس، أعني أنه أساء إلى رسول الله قائلا لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل (المنافقون: 9)، أي أن أعزَّ إنسان في المدينة (وهو يعني نفسَه) سوف يُخرجُ منها أذلَّ إنسان (يعني رسولَ الله ، فداه نفسي وروحي).
وأحيانا كان هؤلاء المنافقون يحرضون الذين وقعوا في بعض الأخطاء بحق القوم ليرتدوا عن الإسلام غضبًا. وأحيانًا كانوا يطعنون في أعمال النبي سعيا لزعزعة إيمان الناس، حيث ورد في القرآن الكريم وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ (التوبة: 58). أي أن بعض المنافقين يطعنون في توزيع الصدقات. وكان هدفهم من ذلك أن ينفِّروا الذين لم يُعطَوا من أموال الصدقات شيئًا.
وكان بعضهم يعرّض بالرسول بأنه سمّاع لكل ما يقال، فكانوا يقولون: هُوَ أُذُنٌ (التوبة: 61)، أي أنه قد نشر الجواسيس في كل مكان، فلا يستطيع أحد التعبير عن أفكاره بحرية.
وأحيانًا كانوا يشمتون في المسلمين إذا أصابهم مكروه، لكي يضعفوا روحهم المعنوية، كما قال الله تعالى: وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ (التوبة: 50)، أي أنه إذا أصاب رسول الله وصحابته المخلصين ضررٌ في الحرب قالوا لقد حصل هذا لأنهم لم يعملوا برأينا، أما نحن فكنا قد أدركنا الخطر سلفًا فلم نشترك في الحرب.
وأحيانا كانوا يحرِّضون الكافرين على المؤمنين، كما قال الله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (الحشر: 12). وبالفعل كان هؤلاء المنافقون كاذبين فيما قالوا للأعداء، لأن أهل الكتاب هؤلاء لما أُجْلوا من المدينة لم يخرج معهم المنافقون، ولما حارب المسلمون أهلَ الكتاب هؤلاء لم ينصروهم، لأن هدفهم الحقيقي لم يكن إلا نشر الفساد ضد المسلمين.
وكان من أساليب إفسادهم أيضا ترويج الشائعات تثبيطًا لعزيمة المسلمين، كما قال الله تعالى: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ (النساء: 84)، أي كلما بلغهم خبرٌ من الأمن أو الخوف أشاعوه على نطاق واسع، إفسادًا بين المسلمين. كان هؤلاء المنافقون ينشرون أخبار الخوف تخويفًا للمسلمين، وإذا بلغهم أمر من الأمن أو الصلح ورأوا أن بعض المسلمين غير مرتاحين له، كانوا يقولون لهم تأجيجًا لمشاعرهم: هذا الصلح إهانة لنا.
باختصار، كان المنافقون يفسدون في الأرض بشتى الحيل، وقد بين الله تعالى هنا أنهم إذا قيل لهم: ما الفائدة من الإفساد في الأرض هكذا؟ قالوا: إنما نعمل كل ذلك من أجل الإصلاح. وهذا أيضا من علامات المنافقين، إنهم يختلقون دائما بعض الأعذار تبريرا لأعمالهم الخبيثة لكي تبدو للناس حسنة، فحينا يقدّمون عذر مساعدة الفقراء، وحينا آخر يختلقون عذر إنقاذ المسلمين من الدمار، ومرة يبررون موقفهم بقولهم: إننا كنا نريد تهدئة ثورة الأعداء. باختصار، إن المنافقين يسعون لإخفاء سوء نيتهم بغطاء حسن النية، ولو لم يفعلوا ذلك فكيف يخفون نفاقهم؟!
يلجأ المنافقون إلى هذه الحيل في كل شعب وفي كل بلد، وعندما تأتي أيام هلاك قوم، فإنهم ينخدعون بالمنافقين ويتخلون عن المخلصين للقوم. ولكن الله تعالى نجَّى الصحابة من خداع هؤلاء وقلب شرورهم على أنفسهم.
إن وجود المنافقين ظاهرة تلازم الجماعات التي فيها نظام دقيق محكم. أما المجتمعات التي تفتقر إلى النظام فلا يضطر أهلها إلى النفاق إلا قليلا. إذا كانت الجماعة منظمة يصعب على ضعاف الإيمان والقلوب تركُها، فيظلون على صلة بها من ناحية، ومن ناحية أخرى يوالون الأعداء سرًّا، ويحيكون الدسائس السرية ضد النظام. والجماعة الإسلامية الأحمدية ذات نظام محكم، فعلينا أن نتوقع وجود المنافقين بين صفوفنا دائما، ووجود المنافقين في جماعتنا دليل على نظامها المحكم، وليس على ضعف فيها. غير أن هناك حاجة إلى أن نفطن لحيل المنافقين التي ذكرها القرآن الكريم، ونعرفهم بها، ونعاملهم بالمعاملة التي رسمها القرآن الكريم، فلا نغترّ بدعاواهم الخلابة، لأنهم يهاجمون متنكرين كالشيطان في زي الناصحين.
شرح الكلمات:
ألا: تفيد تنبيه السامع إلى ما يلقى إليه.
ولكن: “و” و “لكن” حرفا عطفٍ جاءا للتأكيد.
يشعرون: راجع شرح كلمات قول الله تعالى وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ .
التفسير:
كان المنافقون يعنون بقولهم إنما نحن مصلحون أنهم هم المصلحون أما من سواهم الذين يُقال أنهم مسلمون صادقون فهم المفسدون في الواقع، ذلك أن إنما تفيد الحصر، وإذا قال المرء إنما أنا مصلح فيعني أن من سواه ليس بمصلح. وقد رد عليهم القرآن الكريم بقول مماثل فقال ألا إنهم هم المفسدون ، أي استمِعوا أيها المستمعون وعوا، إنما المنافقون هم المفسدون، ومع ذلك يتّهمون غيرهم بالفساد.
لقد أثبتنا من قبل أن المنافقين كانوا يفسدون بأساليب شتى وكانوا يقدمون لأعمالهم الفاسدة تبريرات صالحة في الظاهر، ولكن التبرير الصالح لا يجعل العمل الفاسد صالحًا. إذا كان المرء غير راضٍ بنظامِ أو عقيدةِ جماعة فمن واجبه أن ينفصل عنها، وليس أن يبقى فيها ثم يسعى للإفساد فيها.
لقد بين الله تعالى في آخر هذه الآية أن المنافقين يعوزهم الشعور، ذلك أن النفاق ذو صلة بالقلب، وقوة الشعور هي التي تساعد على معرفة النفاق، فلو أن المنافقين حاولوا مراجعة أنفسهم بدلاً من تقديم تبريرات لتصرفاتهم لأدركوا أن تصرفاتهم لا تهدف إلى الإصلاح إنما منشأها الجُبنُ والخلاف مع جماعة المؤمنين، ولو أنهم فعلوا ذلك لعلموا مرضهم، ولكنهم لا يريدون مطالعة أفكار قلوبهم بشكل صحيح، وبالتالي لا يخدعون الآخرين بل يخدعون أنفسهم.
شرح الكلمات:
آمِنوا: راجعْ شرح كلمات قول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر…
السفهاء: جمعُ السفيه. سَفِه علينا: جهِل. وسفهت الطعنة: أسرعَ منها الدم وخفّ. وسَفِه نصيبَه: نَسِيَه. السَّفَهُ: خفّةُ الحِلْم أو نقيضُه؛ أو الجهلُ، وأصله الخفّة والحركة والاضطراب. والسفيه ذو السفهِ (الأقرب).
السَّفَهُ: الخفّة في البدن، ومنه قيل: زِمامٌ سفيه: كثيرُ الاضطراب؛ وثوب سفيه: رديءُ النسج. واستُعمل في خفّة النفس لنقصانِ العقل، وفي الأمور الدنيوية والأخروية (المفردات).
وسافهتُ الشراب: إذا أسرفتُ فيه (اللسان).
فالسفيه هو: خفيف العقل؛ الجاهل؛ المتقلب الرأيِ؛ قليل الذكاء في الدين والدنيا؛ مَن لا وزن لرأيه؛ مَن ينفق أشياءه القيمة بدون تفكير.
لا يعلمون: علِمه (يعلمه): تيقّنهَ وعرَفه، وإذا كان علِم بمعنى اليقين تعدَّى إلى مفعولين، وإذا كان بمعنى عرَف تعدَّى إلى مفعول واحد. وعلِم الأمرَ: أتقنهُ. وعلِم الشيءَ وعلِم بالشيء: شعر به وأحاطه وأدركه. والعلمُ: إدراكُ الشيء بحقيقته (الأقرب).
فالمراد بقوله تعالى (لا يعلمون) أنهم لا يدركون الحقيقة.
التفسير:
استخدم القرآن الكريم هنا صيغة المجهول (قيل)، ولكن هؤلاء القائلين هم المسلمون كما هو ظاهر مما ورد في الآيات السابقة، والمراد أن المسلمين عندما يقولون للمنافقين آمِنوا كما آمن الشرفاء الآخرون الذين يوفون بعهدهم، فما هذا الهراء إذ تكونون مرة إلى هؤلاء وأخرى إلى هؤلاء، وتقولون بألسنتكم ما ليس في قلوبكم؟ يردّ عليهم المنافقون بقولهم إن هؤلاء الذين تشيرون علينا أن نؤمن مثلهم هم سفهاء إذ يبذلون نفوسهم وأموالهم بإنفاقها بدون هوادة، فهل تريدون منا أن نكون مثل هؤلاء السفهاء؟ إنهم حفنة من الناس ويريدون محاربة العالم كله! عليهم أن يرجعوا إلى صوابهم ويوطدوا علاقات طيبة مع الجميع كما فعلنا نحن.
لقد بيّنّا لدى شرح الكلمات أن من معاني السفه خفّة العقل وإهدار المال بدون هوادة، وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم أيضًا في قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاءَ أموالَكم (النساء: 6)، أي لا تضَعوا أموالكم في أيدي الذين لا يعرفون كيف ينفقونها فيضيعونها. وبهذا المعنى سمَّى المنافقون المسلمين سفهاء، إذ كانوا يظنون أن المسلمين لا يعرفون كيف يحافظون على أنفسهم وعلى أموالهم، بل يهلكون أنفسهم ويهدرون أموالهم لقلة عقلهم. ولكننا أذكياء، حيث أنشأنا مع المسلمين ومع الكفار أيضًا أواصر جيدة، وهكذا نتجنب ضرر الطرفين.
لقد بين القرآن الكريم صراحةً اعتراض المنافقين هذا في مواضع أخرى إذ أخبر أنهم يقولون لأشياعهم :لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا (المنافقون: 8)، أي لا تنفقوا أموالكم عبثًا على هؤلاء الذين التفّوا حول محمد رسول الله ، ولو فعلتم ذلك فسوف ينفضّون من حوله تلقائيا، وتصبحون في مأمنٍ من هذه المعاناة.
كذلك قال الله تعالى: الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ (التوبة: 79)، أي أن المنافقين يسخَرون من المسلمين الذين هم ميسورو الحال ويتنافسون في الإنفاق في سبيل الله، كما يسخرون أيضًا من المسلمين الذين هم فقراء، ومع ذلك يُحضرون ما عندهم من مال قليل. كان المنافقون يطعنون في الفئتين قائلين عن ذوي السعة والمال: انظروا إلى هؤلاء الـمُرائين كيف ينفقون أموالهم رياءً وسمعةً، أما فقراء المسلمين فكانوا يستهزئون بهم قائلين انظروا إلى هؤلاء الحمقى، فإنهم لا يجدون ما يأكلون ومع ذلك يتبرعون بما عندهم من مال قليل.
كما كان المنافقون يطعنون في المسلمين بإزهاق أرواحهم عبثًا حيث قال الله تعالى بعد ذكر الحرب وغلبة الأعداء وكثرتهم: إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاءِ دِينُهُمْ (الأنفال: 50)، أي أن هؤلاء المسلمين قد اغترّوا بما وعدهم دينهم من الرقي والازدهار، ويضحون بأنفسهم في سبيله بدون هوادة ولا يفكرون في المآل.
باختصار، يعني المنافقون بوصفهم المسلمين بالسفاهة أنهم يهلكون أنفسهم ويهدرون أموالهم دون تفكير، أما نحن فنحافظ على أنفسنا ونوفر أموالنا أيضًا.
وهذا الاعتراض يُثار دائمًا ضد الأمم التي تسير في طريق التقدم. كلما أراد الله تعالى الرقيَّ والازدهار لأمةٍ كتبه لها في ظروف مماثلة تمامًا، أعني أنها تكون ضعيفة وبلا وسائل وأسباب، ولكنه تعالى يأمرها بالتضحية بدون هوادة، وهو عملٌ عابث في رأي المنافقين والأعداء، إذ لا يدرون قيمة التضحية، ولكن الأمة حين تحرز النجاح يقول المنافقون والأعداء أن هذا النجاح ليس خارقًا، وإنما مرجعه أن المؤمنين كانوا يقدمون التضحيات، وأعداؤهم كانوا غافلين عن ذلك. وهذا يعني أن المعترضين الآباء كانوا يعترضون على المؤمنين بعكس ما اعترض به أولادهم فيما بعد. ففي صدر الإسلام كانوا يعترضون بأن المسلمين أغبياء، يهدرون أموالهم ويهلكون نفوسهم عبثًا، وينفقون أموالهم ولكنها لن تعود عليهم بنتيجة مُرضية، لقد انخدعوا بما وعدهم دينهم من وعود زائفة، ولكن لمـّا صار الإسلام غالبًا قال أولادهم، أو أظلالهم الموجودون اليوم، أن رُقيّ الإسلام لم يكن خارقًا أو مُعجزًا، كل ما في الأمر أن العرب والفرس والروم كانت أخلاقهم قد فسدت ولم تعُدْ فيهم عاطفة التضحية من أجل الشعب، ولذلك صار المسلمون غالبين عليهم.
والواقع أن المرء إذا ترك الحق فلا يقدر على أن يظل ثابتًا بموقف واحد، بل يُضطر لتغيير موقفه مرة بعد أخرى. ليت هؤلاء يفكّرون أن المسلمين إذا كانوا يمتلكون القوة غير العادية وكان أعداؤهم ضعفاء، فلماذا كان المنافقون داخل الجماعة المسلمة والأعداءُ من خارجها يعدّون تضحيات المسلمين إهدارًا وخططهم جنونًا.
أما قولهم بأنه قد تهيأت عندها أسباب ساعدت المسلمين على الانتصار، فهذا لا ينافي كون غلبة الإسلام معجزةً، ذلك لأن الله تعالى عندما يُنبئ بنبأٍ يُهيّئ لتحقيقه الأسباب أيضًا، ولكنها لا تكون نتيجة جهود المؤمنين. فمتى كان المسلمون يمنعون العرب والفرس والروم من تقديم التضحيات الحقيقية؟ ثم لمَ لا ينظر هؤلاء الطاعنون إلى البون الشاسع بين قوة المسلمين وغيرهم آنذاك. لا شك أن الله تعالى سلَب مشركي العرب والروم والفرس روح التضحية الحقيقية، ولكن ما كان المسلمون قادرين في الظاهر على ردِّ القوة التي بذلها الأعداء لمحاربتهم، فكيف يا تُرى صاروا غالبين عليهم؟
وهناك آيةٌ أخرى تبين أن المنافقين كانوا يرون أن مواجهة الكفار سفاهة وغباء، حيث قال الله تعالى: فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (المائدة: 53)، أي ترون المنافقين الذين في قلوبهم مرض كيف يسارعون للانضمام إلى صفوف أعداء الإسلام، ويقولون إذا هُزم المسلمون فسنلقى مصيرًا سيئًا جدًا، فقل عسى الله أن يُهيئ أسباب انتصار المسلمين أو يأتِي بأمرٍ آخر، فيُصبح المنافقون نادمين بسبب المخاوف التي تنتاب قلوبهم.
والحق أن الفتح والانتصار حقُّ الشجعان البواسل الذين يقدمون التضحيات. والمؤمن أشجع من في الأرض، لأن نظره شاخص إلى السماء دون الأرض. والأمة التي تتهرب من التضحية الحقيقية هالكة لا محالة، والذين يضنّون بأموالهم عن الإنفاق هم الذين يضيعونها، أما الذين ينفقونها في مواضعها فأولئك هم الذين تعود إليهم أموالهم أضعافًا مضاعفة.
لقد بين الله تعالى في آخر الآية أن المنافقين هم الذين يدمّرون أموالهم وأنفسهم، فلا الكفار ينتصرون فتنفعهم صداقتهم، ولا المسلمون ينهزمون حتى ينتفعوا من عدائهم. ولأن هذا الأمر متعلق بالمستقبل فلا يدرونه، ولأنهم لا يؤمنون بالله تعالى فلا يفهمون هذه الحقيقة على ضوء النبوءات الإلهية. ولو علموا ذلك لأدركوا أن سلوكهم هو الذي يعرّض أموالهم وأنفسهم للدمار.
وقد شرح الله تعالى هذا الأمر أكثر في آية أخرى فقال: وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (التوبة: 85)، أي أن المنافقين يتباهون بأموالهم وأولادهم ظانين أنها في مأمن من الضياع والهلاك لأنهم لا يسمحون لأولادهم بالخروج إلى الجهاد، لكن على المسلمين ألا ينخدعوا بتفاخر المنافقين هذا، فرغم أنهم أثرياء وأن أولادهم يعيشون في رغد العيش مطمئنين مرتاحين في البيوت، ولكن الله تعالى سوف يعذبهم من خلال أموالهم وأولادهم في هذه الدنيا، فيغادرون الدنيا في يوم من الأيام أذلاء مهانين في حالة الكفر.
هذه الآية تنطبق على رأس المنافقين عبد الله بن أُبيّ بن سلول أيما انطباق، فقد مات في حياة النبي بعد أن رأى بأم عينه جهوده قد باءت بالفشل بينما حقق النبي النجاح الباهر، بل وصار ابنه من كبار المؤمنين المخلصين، مما زاده خزيًا وأذىً.
