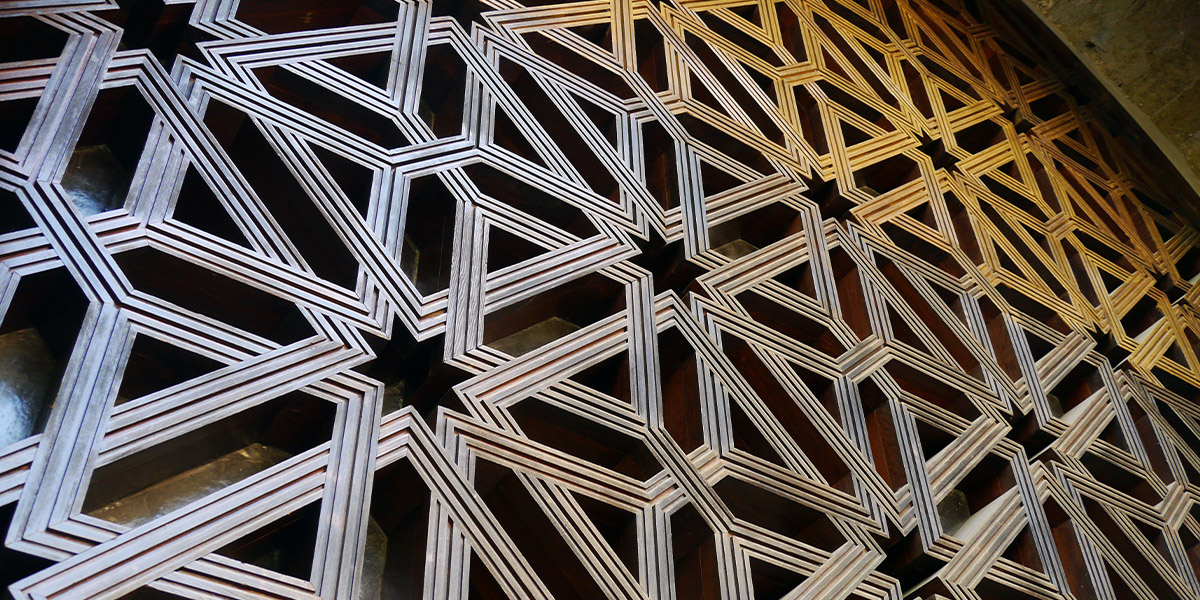
شرح الكلمات:
قضى – لها عدة معاني منها:
1.خلق، كقوله تعالى (قضاهن سبع سماوات)(فصلت: 13).. أي خلق الكون في صورة سبع سماوات.
- أعْلَمَ. كقوله تعالى (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب)(الإسراء:5)
- أمَر: كقوله تعالى (وقض ربك ألا تعبدوا إلا إياه)(الإسراء: 24)
- أقام عليه الحجة وأدانه كقولهم: قضى عليه القاضي.
5.أتم، كقوله تعالى: (فلما قضي موسى الأجل)(القصص: 30)
6.أراد، كقوله تعالى (إذا قضي أمرا)(البقرة: 118)- (الأقرب)
أمرا –الأمر: الدين، يقال ظهر أمر الله: نـزلت أحكامه وشريعته.
والأمر: الشيء، كقوله تعالى (إذا جاء أمرنا)(هود:41)
والأمر: العذاب، كقوله تعالى (قُضي الأمر) (البقرة: 211)
(قضى أمرا) تعني في ضوء القرآن نـزول الإلهام الإلهي.
التفسير:
رغم أن ادعاء اليهود أن لا نجاة إلا لبني إسرائيل ادعاء خاطئ.. إلا أنهم كانوا لا يدْعون الناس إلى دينهم، ولكن المسيحيين رغم زعمهم الخاطئ أن لا نجاة إلا للنصارى، فإنهم يقعون في خطأ آخر.. ذلك بدعوة الآخرين إلى دينهم. كما يبنون خطأهم هذا على عقيدة خاطئة تقول إن المسيح ابن الله، ولا نجاة إلا لمن آمن بابن الله تعالى. وقد دحض الله زعمهم هذا بعدة أدلة، فقال إنه لا تجوز نسبة البنوة إلى الله تعالى، لأته منـزه عن العيوب، ونسبة الولد إليه اعتراف بوجود العيوب في ذاته _جل وعلا عن ذلك.. ومن هذا العيوب:
أولا – إنجاب الابن يقتضي الشهوة، التي تدل على صرْف الفكر إلى شيء وعلى الاحتياج إليه.. والله متعال عن هذه العيوب.
وثانيا –الابن يقتضي وجود الزوجة، وهذا أيضا احتياج ونقص، والله منـزه عن كل منقصة.
وثالثا – الابن يقتضي الجزئية، بمعنى أن الولد جزء من أبيه حيث يتولد من جسمه وذاته. ولو سلمنا بوجود ابن لله تعالى –لاضطررنا إلى الإيمان بإمكان أن يتجزأ الله-سبحانه –إلى أجزاء.
ورابعا- وجود الابن يقتضي الفناء.. لأن الكائنات الفانية هي التي تحتاج إلى ذرية، أما الأشياء التي لا تفتي حتى تحقق الهدف من وجودها فلا تحتاج إلى ما يقوم مقامها، ومثال ذلك الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض وغيرها، فلن تزال هذه الأشياء تعمل كما هي إلى ما شاء الله.. لذلك لن تفنى ولن تحتاج إلى ما يقوم مقامها. ولكن لما كان الإنسان يفنى لذلك يحتاج إلى من يحل محله. فإذا سلمنا بوجود ابن الله.. فلا بد أن نسلم بفنائه أيضا . والله منـزه عن هذه العيب وعن أي عيب سواه.
وقوله تعالى (له ما في السماوات والأرض) يبين أن الملِك في بعض الأحيان يحتاج إلى ولد أو وزير يساعده في توسيع نطاق ملكه، ولكنه – تبارك وتعالى – لا يحتاج لأي مساعد.. لأن الإنسان يحتاج إلى مساعد عندما يصعب عليه تحقيق مطلبه بنفسه، كفتح قطر جديد وضمه إلى مُلكه، ولكن ما دام الله خالق كل شيء ومالك كل شيء فأي حاجة دَعَتْه لاتخاذ ولد؟
ثم إن الملك يحتاج لمساعد مثلا لقمع ثورة في بعض مناطق ملكه النائية، أو لإخضاع أهلها تحت حكمه، ولكن الله – جل وعلا – ليس أحد بخارج عن ملكه، بل كلّ له قانتون.. فكيف والحال هكذا.. تصح عقيدة أن الله اتخذ له ابنا؟
ثم من الممكن أن يقول قائل: لا شك أن مُلكه قد استتب الآن، ولكن لا بد أنه كان بحاجة ابن حين خلق السماوات بسبب كثرة العمل وضغوطه؛ ورد الله على هذه الظن قائلا (بديع السماوات والأرض).. أي أنه بنفسه خلق السماوات والأرض ولم يواجه أي صعوبة في خلقه حتى يشعر بحاجة إلى ابن. فقوله (بديع السماوات والأرض).. ترد على زعم بعض الفرق المسيحية التي تزعم أن المسيح ابن مريم كان شريك الله تعالى في خلق السماوات والأرض.
ونحن نسأل أولئك المسيحيين: ما هو الدور الذي لعبه الابن في خَلْق العالم؟ فإذا قالوا: إنه لا دور له، قلنا: فقد ثبت ألاّ جدوى من وجود الابن. وإذا قالوا إنه خلق العالم، قلنا: ألم يكن الإله الأب بنفسه قادرا على خلقه؟ فإذا قالوا: لا، قلنا: قد أقررتم بالمنقصة في حق الإله الأب. وإذا نـزَّهوه عن نقصه قلنا: فقد كان الإله الأب قادرا على خلقه، فثبت أن المسيح لم يلعب أي دور في عملية الخلق.
ثم نسألهم: هل كان روح القدس قادرا على خَلْقه أم لا؟ فإذا قالوا: لا، قلنا: فقد أقررتم بالمنقصة في روح القدس. أما إذا قالوا: إنه لعب دورا في خلقه، قلنا: فقد اعترفتم بالنقصان في الإله الأب. وما دام كل واحد من الإله الأب والإله الابن وروح القدس قادرا على خَلقه بمفرده أيضا فلماذا خلقوه جمعيا؟ ومثال ذلك أن يكون هناك قلم يستطيع الإنسان رفعه بدون حاجة إلى مساعد، ولكنه لو نادى الجميعَ لمساعدته في رفع القلم لاعتبروه من الحمقى الأغبياء. وما دام الله بمفرده قادرا على خلق السماوات والأرض، فلا شك أن النصارى بقولهم إن المسيح أيضا عمل في خلق الكون ينسبون الله سبحانه إلى الحمق والغباء.. لأنه بدون داعٍ أشركه في عملية الخلق مع أنها لم تكن صعبة عليه.
وأرى أننا لو استخدمنا هذا الدليل في ردِّ أي مسيحي لعجز عن الجواب كما عجز قسيس كبير في مناظرة جرت بيني وبينه في دِلْهَوْزي (الهند). فقد اعترف هذا آخرَ الأمر أن مسألة التثليث في التوحيد والتوحيد في التثليث، مسألة يتعذر على أي إنسان فهمها.
ومن المعلوم أن كلمة (بَدَع) تعني: أوْجَد مِن عَدَم (المفردات). فقوله هنا (بديع السماوات) يدل على أن الروح والمادة كلتيهما حادثة. وبذلك يُبطل الإسلام النظرية الهندوسية بأن الروح والمادة أزليتان (ستيارت بركاش، باندت ديانند، 221).
ثم قال (وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون).. أي أن الله تعالى عندما يريد أمرا فليس هناك ما يحول بينه وبين إرادته؛ وإنما بقول كُنْ يتم تنفيذ مشيئته. وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالى قادر على خلق العالم، كما أن إفناءه أيضا في يده، لذلك فهو لا يحتاج لأي ابن.
وسبب ذكر هذا الأمر أنه كان من الممكن أن يتوهم البعض أن الله تعالى قد خلق الأشياء وأنها كلها خاضعة لنواميسه، ولكن ربما يحتاج لإفناء هذا العالم الموجود إلى مساعد ومعاون. فرد الله على هذا الوهم قائلا إن الفناء أيضا في يده، ولا حاجة له في ابن لإنجاز هذه العملية.
كما أن قوله تعالى (وإذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون) يتضمن تعريضا لطيفا بعقيدة المسيحية القائلة بموت المسيح على الصليب، فهو يقول: إن الله الذي أمات على الصليب ابنه الذي تتخذونه إلها.. أي صعوبة أمامه ليفني العالم كله؟ كان يستطيع أن يهلك الأعداء جميعا بكل سهولة ولا يمكن أن يرد أمرَه شيء.
كما ينبه قوله تعالى (وإذا قضى أمرا) إلى أن إنـزال الوحي أيضا في يده سبحانه؛ فإذا أراد إنـزال وحي جديد إلى العالم فليس في الدنيا قوة تحول دون إرادته. إذن فهذه العبارة تدحض زعم النصارى أن الوحي السماوي الأخير قد نـزل على المسيح (عليه السلام)، ولن ينـزل بعده أي وحي.
لقد سمي المسيح في الكتب المسيحية (الكلمة)، وسماه القرآن أيضا (كلمة الله)، فاستدل المسيحيون منه خطأ أنه قد انقطع نـزول الكلام الإلهي بعد ذهاب الكلمة وكلمة الله. ولكنه – عز وجل- خطّأَهم وقال إنه كما كان يُنـزل كلامه في الماضي فإنه سوف يُنـزله في المستقبل، وكما أنه لم يكن محتاجا إلى أي مساعد لتدبير العالم الروحاني من قبل فإنه لن يحتاج إلى ابن أو مساعد للقيام بهذه المهمة في المستقبل.
وليكن معلوما أن جملة (كن فيكون) لا تعني أبدا أن الله عندما يريد عمل شيء فإنه يحدث على الفور دفعة واحدة، وإنما المراد أنه عندما يريد فعل شيء فإنه ليس كالإنسان بحاجة إلى حركة أو انتقال من وضع إلى آخر، وإنما يريده فيحدث دون أن يحول بينه وبين إرادته أي حائل. كما أن هذه الجملة لا تدل على وقت محدد لحدوث ذلك الشيء، وإنما يحدث بعد إرادة الله في زمن قصير أو طويل قدَّره لحدوثه.
وخلاصة القول: إن الله قد دحض هنا عقيدة بنوَّة المسيح بخمسة براهين، وبين أنه سبحانه وتعالى لا يحتاج لابن، بل هو في غنى عن كل حاجة. ليس من شك في أنه قد أطلق على المسيح في الأناجيل كلمة (الابن)، ولكن كل من له إلمام بسيط بالتوراة يدرك جيدا أن (ابن الله) تعني عند اليهود (حبيب الله) أو نبيَّه. وقد أُطلقت هذه الكلمة في عدة مناسبات على أشخاص آخرين، ولا خصوصية للمسيح في ذلك.. فقد قيل:
(فأجاب وقال لهم يسوع: أبناء هذا الدهر يزوِّجون ويزوَّجون، ولكن الذين حُسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوِّجون ولا يزوَّجون. إذا لا يستطيعون أن يموتوا أيضا لأنهم مثل الملائكة، وهم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة)(لوقا 34:20-36). فقد أطلق هنا أبناء الله على كل من يقِفون حياتهم على خدمة الدين.
وقيل أيضا (طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يُدعون)(متى 9:5). وقد حث المسيح كل المؤمنين لاكتساب هذا اللقب فقال: (لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات). وقال (فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل)(متى 45:5، 48).
وفي كتب موسى أيضا أُطلقت هذه التسمية على المؤمنين فقيل: أنتم أولاد للرب إلهكم)(تثنية 1:14).وقيل: (إسرائيل ابني البكر)(خروج 22:4)إذن فسيدنا يعقوب أولى وأحق من المسيح بأن يكون ابن الله تعالى.. لأن يعقوب كان ابنا بكرا لله في حين كان المسيح ابنا فقط، فكيف يجوز لابن أن يرث أباه والابن البكر موجود. فالمؤمنين كلهم أبناء الله بحسب العهدين القديم والجديد كليهما، وليس للمسيح أية خصوصية في ذلك.
التفسير:
من الناس من يظنون لغبائهم أن الله تعالى يختار أصفياءه بدون حكمة، وبغضّ النظر عن أهلية فيهم واستعداد عندهم. ثم يؤدي بهم ظنهم إلى قول: لم لا يأمرنا الله بما يريد مباشرة حتى لا يحدث أي خلاف؟ لماذا لا يكلمنا مباشرة؟ وإذا كنا لا نستحق التحدث معه فكان المفروض أن يأتي ببرهان ودليل على كلامه مع النبي حتى نؤمن به.
لقد توصلتُ في تحقيقي ودراستي للقرآن أن كلمة (آية) عندما ترد في القرآن منسوبة إلى الله جل وعلا أو إلى الرسل أو المؤمنين فإنها تأتي بمعناها العام.. أي علامة تثبت صدق شيء سواء كانت العلامة عذابا أو إنعاما أو غيرهما من دليل. أما إذا وردت في حق الكفار كان معناها العذاب. والآية هنا بهذا المعنى.. فقد قالوا: كان يجب أن ينـزل الله كلامه علينا حتى نقبله، لأننا أيضا عباده كما هو عبْدُه، فلماذا يميز بيننا وبينه؟ وإذا قيل لنا: إنكم عباده ولكنكم أصبحتم أشرارا واستوجبتم العذاب.. فلم لا ينـزل الله علينا عذابه؟ وما دام لا يهلكنا بعذابه فذلك يعني أننا لسنا أشرارا.. فلماذا إذا لا يكلمنا ويفضِّل محمدًا علينا؟
فقوله تعالى (كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم) يبين بجلاء أن سائر الأنبياء قد واجهوا اعتراضات متشابهة. وعندما كان الإمام المهدي والمسيح الموعود ينصح معارضيه بقياس صِدْقِة على منهاج النبوة المحمدية، كانوا يضيقون بذلك كثيرا ويقولون: لماذا تذكر النبي محمدا ؟ وكان المولوي محمد علي[1] محرر مجلة الجماعة (مقارن الأديان) وقتئذ يرد على هذه الاعتراضات قائلا: إن حضرته نبي من الأنبياء، ولو لم نذكر النبي محمدا كمثال فماذا نفعل؟ ولكن الأسف أن المولوي محمد علي هذا نفسه غيَّر موقفه فيما بعد، وبدأ يقول بأن حضرته لم يدع بالنبوة قط، وأن هذه عقيدة اخترعتها جماعة قاديان. على أية حال يقول الله إنه لو صح اعتراضهم هذا لبطلت رسالات الأنبياء كلهم. فعندما ادعى موسى بتلقي الوحي من الله تعالى لم يتلق الآخرون الوحي مثله. ثم إن الله تعالى لم يُهلك أعداءه دفعة واحدة، وإنما أهلكهم بعد إقامة الحجة عليهم شيئا فشيئا. كما أن المسيح عندما تلقى الوحي لم يشاركه في ذلك غيره، ولم يهلك الله الباقين مرة واحدة. فيجب أن تطبقوا معياركم هذا على الأنبياء السابقين حتى تعرفوا صحة قولكم أو فساده. فإذا لم ينطبق عليهم معياركم هذا ثبت أن قولكم خلاف منهاج النبوة.
الواقع أن المرء عندما لا يجد جوابا يتشبث بعذر يخلِّصه من النقاش. وطالما لجأ أعداء الأنبياء إلى هذه الحيلة، فكلما فشلوا في النقاش أسرعوا إلى مطالبة أنبيائهم بأمور مستحيلة، وهم يعلمون جيدا أن تحقيقها مستحيل لسبب أو لآخر. فهم مرة يطالبون بما يكون مخالفا لسُنة الله تعالى، وتارة يطالبون بتحقيق شيء على الفور وهم يعلمون أنه سوف يتحقق ولكن بعد مدة، وتارة أخرى يطالبون بما يتنافى مع عظمة الله جل شأنه. وعلاوة على ذلك يقولون: لولا يعذبنا الله إن كنا كاذبين.
والنبي المصطفى أيضا مثل الأنبياء الآخرين في هذا الشأن، بل رغم كونه أسماهم مكانة وأعلاهم شأنا عامله أعداؤه بجهل أكثر، فكانوا لا يقدرون على معارضته بالدلائل ويطالبونه بشتى الأمور، وقد ذُكر هنا أمران منها:
أحدهما – إذا كان نبيا صادقا فلم لا يكلمنا الله بشأنه، ويقول لنا إن هذا الرجل صادق فآمنوا به. مع أنه لم يحدث أبدا في زمن أي نبي أن أخبر الله الناس جميعا بالوحي أنه نبي صادق فآمنوا به. حقا أن الله يخبر بعضا من الناس بصدقه بالرؤى والكشوف، ولكن إخبار الجميع خلاف لسنته عز وجل.
ثم إن الناس لا ينتفعون بشهادة من يَشهدون على صدقه بإخبار من الله.. وإنما يتهمونهم أيضا بأن لهم ضِلعا في هذا الأمر.
ثم إن إخبار الجميع بصدق نبي بالإلهام غيرُ مجدٍ، لأن الإيمان ينفع صاحبه إذا ناله بجهد وسعي. وإذا آمن كل الناس بإلهام من الله تعالى فأي فائدة في هذا الإيمان؟ هذا الأسلوب يتنافى مع الهدف من خلق الإنسان، ولا يبقى هناك أي فرق بين الإنسان وغيره من المخلوقات. فالله يخبر أن هؤلاء لا علم لهم بسنة الله، ولا يعرفون أي إيمان ينفع صاحبه. إنهم يطالبون أن يكلمهم الله، مع أنهم يعلمون أن الرسل السابقين الذين هم بهم مؤمنون..قد طولبوا بذلك ولم يتحقق هذا المطلب، ورغم هذا المثال فإن مطالبتهم هذا النبي بنفس المطلب الأول لدليل على أن قلوبهم تشبه قلوب أعداء الرسل السابقين.
والمطالبة الثانية منهم: يجب أن تأتينا آية، فردّ الله بأننا قد أريناكم آيات ينتفع منها الإنسان إذا أراد، ولكن الذين أصيبوا بداء التعصب والعناد فلا دواء لهم. كما أسلفت أن(الآية) هنا تعني العذاب، فالمراد من قولهم (أو تأتينا آية): لِيعذِّبْنا الله بعذاب من عنده، فيرُد الله أنه لا غرابة إذا وجَّهتم مثل هذه الاعتراضات، لأن من خلَفْتموهم ما زالوا يفعلون كما تفعلون. وكما أن الرسول يكون مثيلا لرسول آخر.. كذلك يكون أعداء النبي أشباها لمن كفروا بالأنبياء السابقين. فإذا ادَّعى أعداء محمد أنه لم يُرِ آية فلا جديد في ذلك، لأنهم أشباه أعداء عيسى. وإذا كان أعداء عيسى قد اعترضوا عليه أنه لم يُرِهم آية فلا غرابة في ذلك لأنهم كانوا أشباها لأعداء موسى. وإذا كان أعداء موسى قد وجهوا نفس الاعتراض فلم يكن بدعا منهم لأنهم كانوا أشباها لأعداء إبراهيم. وإذا قال أعداء إبراهيم نفس الكلام فقد فعلوا ذلك لأنهم أمثالُ أعداء نوح. قد تشابهت قلوبهم وقلوب السابقين.. لذلك يقولون اليوم لولا تأتينا بآية، مع أن هناك آيات عديدة للذين يريدون الإيمان، أما الذين لا يريدون الإيمان فلا يبصرون أيّة آية.
وبين قوله تعالى (تشابهت قلوبهم) أن أتباع كل نبي يسيرون على نهج أتباع الأنبياء الآخرين، كما أن الكافرين بنبي يتبعون سنن الكفار السابقين. فالأنبياء يشبهون الأنبياء من قبلهم، وجماعتهم تشبه الجماعات السابقة، والكفار يتشابهون مع الكفار السابقين.. ولا سيما الأنبياء الذين يكونون في المهمات المنوطة بهم مشابهين لأنبياء آخرين فتكون أحوالهم شديدة الشبه.
وبقوله تعالى (قد بيَّنّا الآيات لقوم يوقنون) يعني أنكم تطالبون بالعذاب لتعرفوا صدق هذا النبي.. والواقع أننا أريناكم آيات عديدة وبراهين كثيرة تتيح لكم معرفة صدقه.. شريطة أن تكونوا صادقي النية بعيدين عن التعصب والعناد. فإذا كنتم أمناء في مطالبكم فلم لا تُعْمِلون فكركم في هذه الآيات والبراهين، ولماذا تصرّون على نـزول العذاب. لو كان الغرض من بعث الأنبياء إهلاك العباد لما بعث الله نبيا إلا وأهلك سائر الكفار على الفور. ولو كان الأمر كذلك لم يؤمن به أحد. لذلك جرت سنة الله أنه عندما يبعث نبيا يُري في أول الأمر آيات رحمته.. كي يؤمن من يريد الإيمان، ثم يهلك الله بعذابه الكافرين المطبوعين على التعصب والعناد.
وفي قوله تعالى (لقوم يوقنون) إشارة لطيفة إلى أن الله قد أظهر آيات كثيرة، ولكن كيف يؤمن الذي يتشكك ويرتاب في كل شيء؟ فإن كنتم تريدون الهداية فاتركوا عادة التشكك والارتياب، وتحلّوا باليقين. كيف يستطيع رؤية الآيات من يرفض كل آية ثم لا ينفك يردد قوله: أرني آية، أرني آية؟ وفي بلدنا يقولون إنك تستطيع أن توقظ النائم، ولكنك لا تقدر على إيقاظ من ليس بنائم!
وليس المراد هنا من الآيات آيات القرآن، وإنما المراد الأدلة والبراهين التي لا بد منها لإثبات صدق نبي. فقوله تعالى يدحض اعتراض المسيحيين أن النبي لم يُرِ أيّة آية، لأنه يقول: قد أريْنا كل أنواع الآيات بكل وضوح لقوم يوقنون.
شرح الكلمات:
بالحق –حال للفاعل أو المفعول به، وتعني مع الحق (إملاء ما مَنّ به الرحمن – تحت هذه الآية).
التفسير:
يجب أن نتذكر دائما قاعدة هامة في بيان معاني القرآن، وهي أنه إذا كانت آيه ما تحتمل عدة معان لا يتنافى منها أي معنى مع آية أخرى.. فيمكن اختيار تلك المعاني كلها، لأن القرآن يفسّر بعضه بعضا. وكلمة (بالحق)هنا تحتمل أربعة معان: فإذا اعتبرناها حالا للفاعل كان المعنى: إنا أرسلناك والحق معنا. ولهذه الجملة معنيان: الأول – إنا أرسلناك وكنـز الحق والصدق عندنا دون سوانا، فلا يستطيع أحد سوى الله أن يقدّم مثل هذا التعليم الصادق الحق؛ لأنه لو حاول ذلك لما تجنب الكذب فيه، وارتكب فيه – عمدًا أو سهوًا – أخطاء كثيرة فادحة تجلب على العالم الخراب.. فكنا أوْلى بإنـزال هذا التعليم الذي يهدي إلى الحق.
والثاني –إنا أرسلناك ونحن أحق بإرسالك. كأنه عز وجل يقول: نحن بديع السماوات والأرض فنحن صاحب حق في إنـزال هذا التعليم. نحن خالق هذا الكون ومالكه.. وبديهي أن واضع نظام العالم هو صاحب الحق في الحكم، وليس لأحد سواه أن يتدخل في ذلك.
يقول الآريون الهندوس إن الله لم يخلق الروح والمادة (ستيارث بركاش، ص 221). هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يقولون: إن الله هو الذي يسن قوانين الكون. وهذا خطأ، لأن الذي لم يخلق لا حق له في سن القوانين، وإنما يحق ذلك لمن كان خالقا ومالكا.. لأنه أعلم بحاجات خلقه. أما الذي لم يخلُق فأنّى يكون له اطلاع على ما يختلج في قلوب خلقه من مشاعر وأحاسيس، وأنّى له العلم بما ينفعهم وبما يضرهم؟ فلا بد أن يسن قوانين تسبب لهم العثار والهلاك.
ثم إذا اعتبرنا كلمة (بالحق) حالا من المفعول به يكون لها معنيان آخران:
المعنى الأول – إنا أرسلناك حال كون الحق والصدق معك. فلو كان ما عندك من تعليم هو من وضع الإنسان لكان هناك احتمال كبير لوجود الخطأ أو الكذب أو أي عيب آخر؛ ولكن ما أوتيت من تعليم فهو منـزّه عن كل عيب. وما دام كذلك.. فلا بد من الاعتراف بأنه من عند الله تعالى.
والثاني- إنا أرسلناك حال كونك أحق بالرسالة والتشرف بكلام الله. وبذلك ردّ الله على اعتراضهم: لولا تأتينا آية، وقال: حيث إنك كنت أحق بالرسالة لذلك أرسلناك. ولو كان هؤلاء أصحاب هذا الحق لآتيناهم إياه وأرسلناهم لهداية الناس. وهنا سؤال: ما هو موقف باقي الناس؟ فردّ الله بقوله (بشيرا ونذيرا). إن الناس نوعان: فمن آمنوا بكلامنا الذي أنـزلناه على هذا الشخص وقد كان أحق الناس به.. فإن لهم بشارات وأخبارا سارة. وأما الذين يرفضون فيدخلون في الكاذبين وينالون نصيبهم من العذاب.
(بشيرا ونذيرا) يعني: أنك تحمل للبعض أخبارا سارة، وللبعض الآخر وعيدا وإنذارا. فهذه الآيات نوعان: منها ما ينجي البعض، ومنها ما يهلك البعض الآخر. والآيات التي تحمل البشرى تأتي أولا، ثم تليها الآيات التي تحمل إنذارا: لأنك أوّلا بشير ثم نذير؛ فمن سنة الله تعالى أنه إذا أراد نجاة فريق وهلاك آخر فإنه يُظهر الآيات المنجيات لينجو من أراد.
وخلاصة القول أن الآية تقول: يا محمد إنك تتصف بصفات أربع:
أولا – إنك مرسل بالحق.
ثانيا- إنك بشير للذين سوف ينجون من العذاب بالإيمان بك.
ثالثا- إنك نذير للذين سوف يهلكون بسبب الكفر بك.
رابعا- تنـزل عليك الآيات لأنك أرسلت بالحق.
وبقوله تعالى (ولا تُسأل عن أصحاب الجحيم) يعلن الله أن رسولنا مكلّف بتبليغ الرسالة، لا بإجبار الناس على قبولها. فإذا ما استحق البعض عذاب النار نتيجة كفرهم برسالتنا فليس عليه من شيء. وكأن الله تعالى يقول: إنا أرسلناك بالحق، فمن آمن بك نجا وأفلح، ومن كفر بك خسر وهلك. وهذه هي الآيات والعلامات التي أظهرنا لإثبات صدقك. ولكن الدليل إنما ينفع من يريد الحق، أمّا من أصرّ على الإنكار في كل حال فلن ينفعه الدليل شيئا.. كما حدث لحبرين يهوديين زارا النبي ذات يوم، وعند رجوعهما سأل أحدهما الآخر: ما رأيك فيه؟ قال: أرى أنه على الحق، ولكني لن أصدِّقه ما حييت. فقال الأول: وهذا عين ما انتويتُه أنا أيضا (السيرة لابن هشام، عداوة اليهود، شهادة صفية).
يقول الله: إننا قد خلقنا كل إنسان حرا، وخيّرناه تماما في قبول الحق أو رفضه، وما دام هناك فئة من الناس لا تنفك تصر على الإنكار على كل حال.. فكيف يمكن يا محمد، أن تُلام على إنكارهم؟!
شرح الكلمات:
أهواء –يطلق الهوى لغة على أمنية رذيلة مُنحطة، وهو من الهوْء: أي ما سقط في مكان عميق القعر (الأقرب). وفي ذلك إشارة إلى أن أمانيهم تحط من شأنهم وتذلهم. إن من ميزة القرآن الكريم أنه يراعي المعاني الحقيقية والمجازية في استعمال الألفاظ.
وليّ– الولي الذي يدبر أمور أحد. ويُطلق على صديق يكفل تدبير أموره. ومن معاني الولاية الحكم (المنجد)، فالولي هو من يكون وكيلا وكفيلا لأحد.
نصير– النصير هو المساعد. والفرق بين الولي والنصير أن الولي يتولى تدبير أمور الغير كلية، أما النصير فيساعد صاحب العمل في تدبيره.. ذلك لأن العون على نوعين: الأول –أن يتحمل الإنسان عبء مسئولية عمل بالتمام نيابة عن صاحبه، والثاني – أن يتحمل جزءا من المسئولية.
التفسير:
تبين الآية السبب الحقيقي للخلاف، موضحة أنه لن يرضى اليهود والنصارى عنكم حتى تقبلوا قولهم. ولكن هذا مستحيل..لأن الله تعالى قد هداكم بنفسه إلى الحق. وما دام هؤلاء لا يتضعضع إيمانهم.. مع أن إيمانهم تقليدي لا يتأسس على أدلة وبراهين، وإنما يقوم على العصبية، ولا يؤمنون بالحق بعدما تبين لهم، فكيف يمكن لمن هداه الله إلى الحق أن يتركه بعد ما تبين له.
(قل إن هُدى الله هو الهدى) أي قل لهم: اتركوا هذا الإيمان التقليدي، واتبعوا بدلا منه هدى الله الذي تحقَّق صدقُه.. لأن الهدى الحقيقي هو ذلك الذي يأتي من عند الله تعالى. أما أن يختلق الإنسان من عنده معايير ومقاييس للهدى ثم يعتبرها مدارًا للنجاة.. فهذا كذب ليس من الحق في شيء، وإنما تُكتب النجاة لمن يتقبل الهدى الذي يأتي من عند الله، ويعمل به.
قوله تعالى (ولئن اتبعت أهواءهم) وإن كان يخاطب الرسول إلا أنه في الحقيقية موجه إلى أتباعه. فإن الرسول أسمى وأرفع من أن يظن أنه يعصي الله في شيء، فقد أوضح الله في القرآن الكريم شأنه فقال (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) (الأحزاب: 32). وقال (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) (الأحزاب: 22) إذن، لا يمكن أن يكون الخطاب موجها إلى الرسول ، وإنما هو لمتبعيه.
وتشير كلمة (أهواءهم) إلى أن الأماني السيئة تهوي بالمرء من المكانة السامية إلى السفلى، بينما تحدوه الأماني الحسنة إلى الرقي والازدهار. إذا تعثر أحد في الظلام وسقط عَذَرَهُ الناس، ولكن إذا سقط أحد وهو يعلم فلا يُعفى عنه. كذلك إذا أخطأ أحد لجهله بالحقيقة استحق العفو، ولكن الذي كفر بالحق بعدما تبين له فلا يستحق العفو ولا الصفح.
وقوله تعالى (ما لك من الله من ولي ولا نصير).. يبين أنه لن يجد أحدا يتحمل المسئولية كليا أو جزئيا.
وأشار بقوله (من الله) إلى أن الله تعالى إنما يمد بعونه من لا يكون تابعا لأهوائه النفسانية، بل يتبع هدى الله جل علاه.
شرح الكلمات:
يتلون – من تلا يتلو: قرأ. فمعنى (يتلونه حق تلاوته):يقرءونه كما ينبغي أن يقرأ، أو أنهم يُعمِلون فكرهم ويتدبرون فيه أثناء قراءته كما يجب. تلا: اتبع (الأقرب)، كقوله تعالى (والقمر إذا تلاها) (الشمس:3)..أي تبع الشمس. فالمعنى أنهم يتبعونه حق اتباعه ويعملون به كما ينبغي.
التفسير:
لقد انخدع الناس وظنوا أن المراد بالكتاب هنا هو التوراة، ولكن هذا المعنى لا ينطبق هنا. لأن ذلك يعني أن الذين آتيناهم التوراة يتبعونها كما يجب الاتباع، ويؤمنون بها حق الإيمان، والحال أن اليهود لا يعملون بالتوراة، ولا النصارى يعملون بالإنجيل. فلا يكون المراد من الكتاب إلا الكتاب الذي يعمل به أهله.
ثم أن الله أخبر بأن التوراة والإنجيل لم يبقيا محفوظين في حالتهما الحقيقية، بل قد عبثت أيدي المحرفين بهما إلى زمن النبي حيث قال عن اليهود (.. يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله)(البقرة: 80).. أي أنهم يضيفون من عندهم بعض الأمور إلى التوراة، ثم يقولون إنها من وحي الله. وبعد هذا التحريف الشديد لا يمكن الإشادة بهؤلاء والثناء عليهم.. وإلا فلم يبق هناك أية حاجة لنزول القرآن، واعُتبر تعليم التوراة والإنجيل كافيا لهداية الناس. فالواقع أن المراد من (الكتاب) هنا هو القرآن الكريم، وليس التوراة.
وقد انخدع المفسرون هنا لأن الله تعالى قد سمّى اليهود في مواضع أخرى (أهل الكتاب)، ولكن كان على المفسرين أن يراعوا دائما القرائن في تحديد ماهية الكتاب. لو لم يكن هذا اللفظ مشترك المعنى لما كان هناك أي نقاش، ولكن ما دام اللفظ مشترك المعنى بين هؤلاء والمسلمين.. كان من اللازم مراعاة القرائن ومراعاة الفريق الذي يصدّق عليه معنى الآية. وقد قال قتادة (الذين آتيناهم الكتاب) هم أصحاب رسول الله .(تفسير ابن كثير، تحت هذه الآية).
الحقيقة أن الله تعالى يدين اليهود في هذه الآية ويقول لهم: إنكم نبذتم التوراة وراء ظهوركم، ولكن الله أعطى المسلمين القرآن الكريم، فهم يعملون به كاملا، ويمتثلون لكل أمر من أوامره لتوطيد دين الله. تزعمون أن ما عندكم هو الكتاب الحق الصادق، مع أنه لو كان كذلك لعملتم به، ولصرتم أهل صلاح، ولكنكم بأنفسكم تعترفون أنكم فسدتم. فكان لا بد من أن يأتي الله الآن بقوم يقيمون دينه من جديد ويظهرونه ببذل مالهم وراحتهم وأرواحهم. فما دام هؤلاء يُضحون بكل ذلك للإسلام فثبت أن هؤلاء هم أهل الحق، وأن الكتاب الذي يؤمنون به هو من عند الله، لأن الكتاب الذي يهب الهدى ويقيمه في الدنيا هو الذي يعتبر من عند الله تعالى.
وقوله تعالى (أولئك يؤمنون به) يذكر إيمانا ليس تقليديا. الحق أن هناك نوعين للإيمان: الأول – ما يتم بالدليل، ولكن هذا النوع من الإيمان لا يصل بالإنسان إلى مقام الشهود والعيان، وإنما مثله أن يطيع الإنسان أوامر الملك أو الحاكم. والنوع الثاني هو إيمان الانكشاف والعيان. وعندما يحصل الإنسان على مثل هذا المقام في الإيمان يتم له وصال بالله تعالى، ويتحول إيمانه التقليدي العادي إلى إيمان حقيقي يصبح جزءا من نفسه، ويكسبه البشاشة القلبية، فلا يبقى بعده أي خطر للارتداد أو العثار.
وقوله تعالى (ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون) أيضًا يؤكد أن الكتاب هنا هو القرآن الكريم، وليس التوراة.. لأن المؤمن بالقرآن، المنكر لما يقدمه اليهود على أنه التوراة لم يكن من الخاسرين.. وإنما العاملون بتلك التوراة والرافضون للقرآن الكريم كانوا هم الخاسرين. إن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي إذا رفضه الإنسان صار من الخاسرين، ولكن المؤمن به والرافض لما سواه مما يقدم على أنه كتب سماوية لا يكون من الخاسرين، وإنما من المنتفعين والحائزين على رضوان الله تعالى.
الترتيب والربط:
في الآية 114 بين الله سيئة أخرى لدى اليهود والنصارى.. أنهم تعصبا وعنادا يرمون بعضهم البعض بالشر والفساد، ولا يعترفون بأي خير في الفريق الآخر، مع أنهم -لا بد- مشتركون في بعض الأمور الحسنة.. لاشتراكهم في الإيمان بكتاب واحد.
وفي الآية 115 بين أن هذه البغضاء قد اشتدت وتأصلت بينهم لدرجة أنهم لا يطيقون رؤية بعضهم البعض وهم يتعبدون. ولا يسمحون للفريق الآخر بأداء عبادته في معابدهم، مع أن الواجب عليهم أن يكونوا حذرين محتاطين تماما في شأن أماكن عبادة الله تعالى.
وفي الآية 116 نصح الله المسلمين بعدم الخوف من معارضتهم وعداوتهم، لأن هؤلاء المعارضين صاروا محط غضب الله، فأينما اتجه المسلمون فلسوف يهيئ الله الأسباب لنجاحهم وفلاحهم.
وفي الآية 117 نبّه المسيحيين – وهم فرع من اليهود – إلى معاصيهم ليعرفوا لماذا لم يولد فيهم النبي الموعود، ولماذا حُرِموا من نعمة كلام الله تعالى.
وفي الآية118 دحض بثلاثة أدلة العقيدة المسيحية الخاطئة ببنوة المسيح لله.
وفي الآية 119 رد على اعتراضين منهم، أولهما: إذا كنا على خطأ فلماذا لا يخبرنا الله بالإلهام والوحي، وثانيهما: إذا كنا خاطئين فلماذا لا يعذبنا الله على معارضتنا لهذا النبي.
وفي الآية 120 بين أن كل رسول يكون بشيرا ونذيرا، فلا بد أن يأتي العذاب ولكن على مهل.
وفي الآية121 بين السبب الحقيقي لمعارضتهم المسلمين، وهو أن تعاليم القرآن لم تنـزل بحسب أهواء هؤلاء المعارضين. ورد على ذلك بأن الصراط المستقيم هو ما يقيمه الله عليه.. فالذي يرى طريق الهدى ومع ذلك يركن إلى الضلال فلا بد أن يعاقب.
وفي الآية 122 بين أن المسلمين الذين أعطيناهم القرآن ويعملون به تماما سوف يحققون الفلاح في آخر المطاف، ولن يكون من الخاسرين إلا الذين يرفضون هذا الكتاب ولا يؤمنون به.
