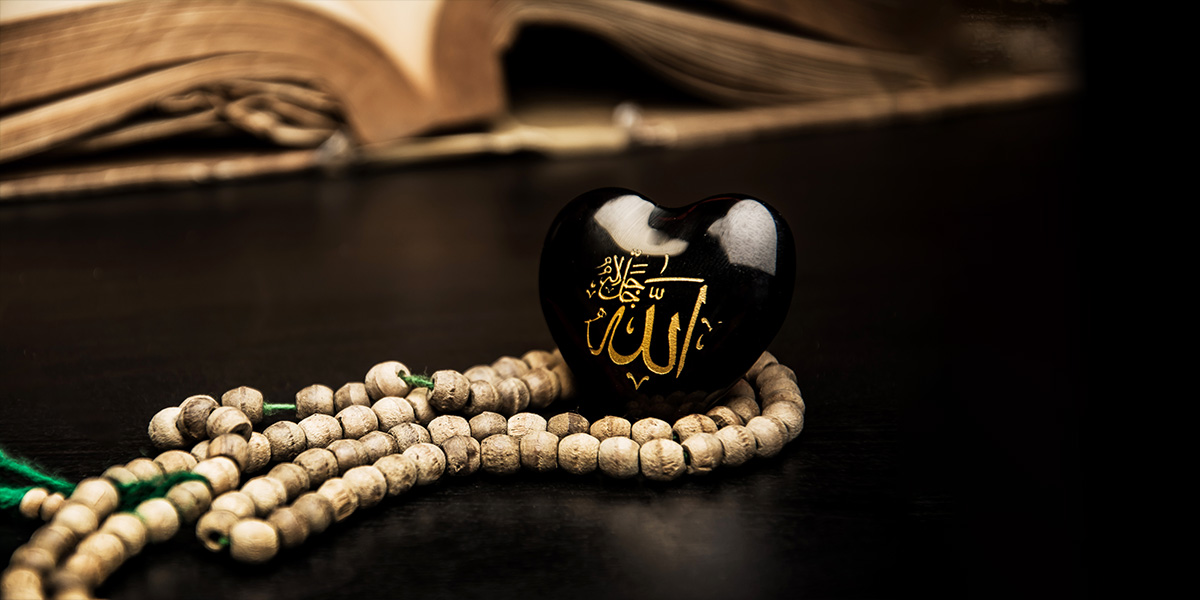
- ما الصفات الواجب توافرها مجتمعة في الإله الحق؟
- ما الأساس الذي بنى عليه سيدنا إبراهيم إيمانه بالله وكفره بالأصنام؟
___
التفسير:
اعلم أن يا أَبَتِ هو في الأصل «يا أبي»، فأُبدلتِ ياءُ المتكلمِ تاءً، حيث تقول العرب: يا أبي، ويا أَبَتِ.
أما قوله تعالى ما لا يسمَع ولا يُبصِر فيبيّن أن السمع والبصر من أهم صفات الله تعالى، أما الصفات الأخرى فهي تابعة لهما. فلولا أن الله تعالى سميع وبصير لما بقي على وجوده برهان يمكن مشاهدته. فإن أكبر دليل على وجود البارئ تعالى إنما هو استجابته أدعيتَنا، حيث ندعو الله تعالى يا ربِّ حقَّقْ لنا أُمنيّتنا كذا، فيتحقق ما نريد، فنعرف بذلك أن الله تعالى موجود. أما إذا لم يثبت أن الله تعالى يسمع ويرى فلا يمكن للبشر الاتصال به ؛ إذ لا يمكن الاتصال بالغير إلا بطريقين اثنين: إما الأذن أو بالعين؛ فالإنسان يدرك بسماع صوت أحد أنه في حاجة إليه، فيأتيه لمساعدته، أو أنه يرى أحدًا فيدرك أنه في مصيبة، فيسرع إلى نجدته. فلا يمكننا تقديم البرهان على وجود إله هو على صلة مع البشر إلا إذا كان موصوفًا بصفة السمع والبصر. وهذا هو البرهان الذي يذكره إبراهيم هنا على بطلان عبادة الأصنام، فيقول يا أبتِ لم تعبُد ما لا يسمَع ولا يبصِر؟ أي ما الجدوى من عبادة الأصنام العارية من هاتين الصفتين؟
ثم يقول ولا يُغني عنك شيئًا. يقال «ما أغنى فلان شيئًا: لم ينفع في مُهِمٍّ ولم يَكْفِ مَؤُونةً» (الأقرب). فمثلاً لو كان على المرء دَينٌ، فدفع غيره دينه نيابة عنه، أو لو كان هناك مريض فسعى أحد لعلاجه، فإنه قد أغنى عنه، وكفاه في حمل هذا الثقل. فيقول إبراهيم لأبيه إن هذه الأصنام لا تغني عنك شيئًا، ولا يمكن أن تحمل عنك أي حمل ولا ثقل، فما الفائدة من عبادتها؟
والحق أن قوله ولا يغني عنك شيئًا تتمة للدليل الذي ذُكر في قوله تعالى ما لا يسمع ولا يُبصر. ذلك أن المرء لو كان لديه أُذن، ولو سمع صوت شخص يستنجد به من مكان بعيد، ولكنه لا يقدر على نجدته لكونه أعرج لا يقدر على المشي، فما الفائدة من سمعه؟ أو لو رأى شخصًا يوشك على الغرق، ولكنه لا يملك من الهمة ما يدفعه إلى إنقاذه فما الجدوى من بصره؟ إن السمع والبصر إنما ينفعان ما دام صاحبها قادرًا على النصرة والنجدة. فثبت أن الدليل المذكور في قوله لا يغني عنك شيئًا إنما هو يكتمل بالجملة السابقة ما لا يسمع ولا يبصر. ذلك أن المرء يطلع على مصيبة غيره بطريقين اثنين: إما بالسمع أو بالبصر. ولكن مجرد السمع والبصر لا يكفيان إذا لم يكن صاحبهما قادرًا على تحقيق نيّته في نصرة غيره، أما إذا قدر على ذلك صارت صداقته ذات جدوى فعلاً. فلذلك يقول إبراهيم إن هذه الأصنام لا تسمع نداءك، ولا تبصر بليّتك، ولا تقدر على أن تكفيك في رد بلاء؛ أفليست عبادتها إذًا حماقة ما بعدها حماقة؟
فليكن معلومًا بهذا الشأن أن الله تعالى قد ذكر في قوله ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئًا ثلاثة أمور كل واحد منها وثيق الصلة بالآخر، وكلها مجتمعةً تشكّل الدليل.. أي أن هذا الدليل القرآني يكتمل باجتماع السمع والبصر والإغناء كلها، بمعنى أنه إذا اكتملت هذه السلسلة المتكونة من هذه الحلقات الثلاث فلا يمكن أن يُعَدّ الأمر صدفةً، ولا يمكن أن يعزى إلى صنم من الأصنام
قد يقول هنا قائل: من ذا الذي يزعم أن الأصنام لا تسمع أو لا تبصر؟ كلا، بل إنها تسمع وتبصر بحسب اعتقادنا. وإذا كانت أصنامنا لا تسمع ولا تبصر بحسب رأيكم، فما هو دليلكم أنتم على أن ربكم يسمع ويرى؟
والجواب أن الدليل على أن ربنا سميع هو أنه يجيب دعاءنا وابتهالنا. وأما الدليل على كونه بصيرًا فهو أنه عندما يرانا في مصيبة يأتي لنجدتنا. فعون الله لنا وتلبيته لحاجاتنا لبرهان أكيد على أنه يسمع ويرى. ولكن الأصنام لا تلبي لأحد حاجة، ولا تساعده في مصيبة، فثبت أنها لا تسمع ولا تبصر، إذ كيف يمكن أن تسمع هي صوت مستنجد أو ترى أحدًا في بلية ومع ذلك لا تأتي لنجدته؟
ورد في الحديث أن أحد الصحابة قال إن ما هداني إلى الإسلام هو أننا في الجاهلية كنا نحبّ الأصنام جدًّا، حتى إذا خرجنا في سفر أخذنا معنا صنمًا لكي نكون ببركته في مأمن من البلايا والمصائب. وذات مرة خرجتُ في سفر وأخذت معي صنمًا، وفي الطريق تذكرت حاجة، وأردت الذهاب إلى مكان لسدّها، وكان معي متاع كثير لم أقدر على حمله معي. فتركت أمتعتي في العراء، ووضعت الصنم عندها وقلت: سيدي، أرجوك حراسة متاعي حتى أعود من حاجتي. فرجعتُ فرِحًا مطمئنًا بأني قد وضعتُ متاعي تحت رعاية ربي. ولما رجعتُ وجدت ثعلبًا قد رفع رجله يبول على الصنم. فغضبت غضبًا شديدًا ورميت الصنم بعيدًا، وقلت: لم تقدر يا لعينُ على حماية نفسك من الثعلب الضعيف، فأَنَّى لك أن تحرس متاعي؟ فقلت في نفسي إن ما يقوله المسلمون حق، فلما رجعتُ أسلمتُ.
ويقول صحابي آخر: أردت أن أخرج في سفر، وكان عندي متاع كثير، ففكرت أن حمل صنمٍ حَجَريٍ في السفر مع المتاع الكثير صعب. فصنعت صنمًا من دقيق وأخذته معي في السفر. فنفد الطعام في الطريق، ولم يبق معنا شيئًا لنأكل، ولما جهد بنا الجوع كسَرتُ الصنم وعجنت العجين وصنعت منه الخبز وأكلته. وقلت في نفسي ما هذا الإله الذي قد أكلتُه، ولم يضرني شيئًا؟ فأسلمتُ. (1)
هذا هو المراد من قوله تعالى ولا يغني عنك شيئًا. قد يقول قائل هنا: إن ما يتمنى الناس يتحقق لهم على طريق الصدفة أيضًا، فكيف يُعتبر تحقُّق أمانيهم دليلاً على وجود الله تعالى؟ فمثلاً يُرزق البعض ابنًا فيقول إن هذا ببركة سجودي لقبر فلان من أولياء الله تعالى، أو إذا حالفه النجاح في أمر قال إن هذا ببركة الطعام الذي وزعته على ضريح فلانٍ من الأولياء.فليكن معلومًا بهذا الشأن أن الله تعالى قد ذكر في قوله ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئًا ثلاثة أمور كل واحد منها وثيق الصلة بالآخر، وكلها مجتمعةً تشكّل الدليل.. أي أن هذا الدليل القرآني يكتمل باجتماع السمع والبصر والإغناء كلها، بمعنى أنه إذا اكتملت هذه السلسلة المتكونة من هذه الحلقات الثلاث فلا يمكن أن يُعَدّ الأمر صدفةً، ولا يمكن أن يعزى إلى صنم من الأصنام. فمثلاً إذا دعا المرء لأمر، ثم تحقق مطلبه، نستنتج من ذلك أن تحققه نتيجة لاستجابة الله لدعائه. ولكن إذا لم يكن هناك أي دعاء، كما لم يكن النجاح غير عادي، فلا يمكن أن يُعتبر ذلك نتيجة الدعاء، إذ تقع في الدنيا بعض الأمور عن طريق الصدفة أيضًا.
شرح الكلمات:
سَوِيًّا: السويّ: هو المستوي؛ وأيضًا الاستواءُ والإنصاف (المنجد).
التفسير:
قوله أَهْدِك صراطًا سويًّا يعني أُرشِدُك إلى صراط خال من العوج، لا إفراط فيه ولا تفريط.
إنني أرى أن أكبر اختبار واجه إبراهيمَ في حياته إنما هو أنه كان عليه أن يذهب إلى أبيه، أو لعمه عند البعض، ويقول له: يا أبتِ إني قد جاءني من العلم ما لم يأتِك فاتبعْني أهدِك صراطًا سويًّا. ذلك لأنه من الصعب جدًّا أن يقول المرء للكبار مثل هذا الكلام. كان أكبر ابتلاء مر به إبراهيم في حياته هو أن الله تعالى بعثه في زمن كان أبوه الذي أنجبه، أو عمه الذي رباه، موجودًا فيه، فاضطر لأن يقول له إنك يا أبي على الخطأ فاتَّبِعْني أهدِك صراطًا سويًّا.. وكأنه قال لـه: يا أبت، اليوم أنا أبوك وأنت ابني من حيث الروحانية. لا شك أن الأولاد يتكلمون بمثل هذا الكلام بسبب سذاجتهم أحيانًا، فمثلاً يأتيني أحفادي الصغار في بعض الأحيان وعندما أُمسك بيد أُمّ بعضهم حبًّا وحنانًا وأقول أمامه: هذه بنتي، فيقول هذا الصغير أيضًا: هذه بنتي. هذا صحيح بالنسبة للأطفال الصغار، ولكن من الصعوبة بمكان أن يذهب الفتى إلى أبيه ويقول لـه يا أبي، لم تَعُد منذ اليوم أبًا لي، بل صرتُ أنا أبًا لك. ولستَ أهلاً لتربيتي، لذا فمن الآن فصاعدًا لن تنبهني على أخطائي، بل أنا سأنبهك على أخطائك. إن التفوه بهذا الكلام صعب جدًّا جدًّا.
